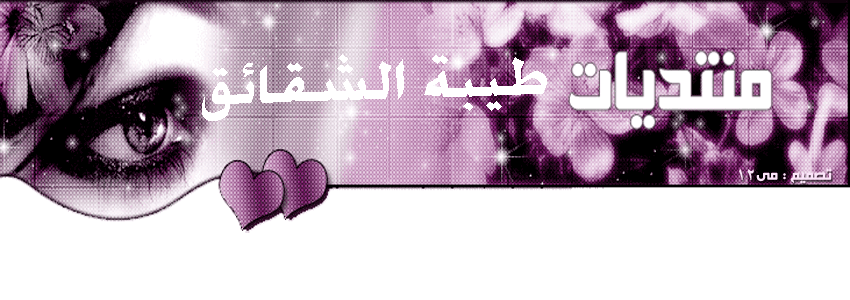أقطن في بناية ذات ثلاثة طبقات تطل على شارع أبي بكر الصديق بـ «مصر الجديدة» تجاورها بناية نحيلة مكونة من خمسة طوابق يطل مدخلها المعتم الكابي على شارع هارون الرشيد بينما تنتصب في باحتها الأمامية شجرة عتيقة أخذت تستحوذ على مركز تفكيري شيئاً بعد شئ، وحتى الآن.. لا أدري ما الذي يشدني إليها على ذلك النحو الآسر.
كان بين البنايتين ممران جانبيان يفصل بينهما حائط قصير. ومع ذلك.. كانت محض شجرة.. لا تثير في دواخلي أدنى خلجة من تلك الأحاسيس.. عندما أراها كاملة أثناء سيري في شارع هارون.. قبل أن أنحرف يسارا نحو بنايتي.. حيث درجت منذ مدة على ممارسة حياتي العادية بين جدران غرفة السطح المؤجرة.. وقد احاطت بي من كل ناحية هوائيات الإرسال التلفزيوني مثل شواهد مقبرة مسيحية قديمة.
كنت في بعض الأحيان اتوقف في شارع «هارون»، أطيل النظر إليها من فوق رصيف الشارع الأسمنتي الصلب كخبير نبات. أتمعن فيها بروية.. باحثاً بجهدي له عن سر تلك الأحاسيس.. التي ظلت تجتاحني كلما أبصرت فروعها العالية العالية «من هناك».
كذلك.. وعلى الدوام.. بدا الأمر لي من هذه الزاوية:
مجرد شجرة «عادية».. تكاد تحتل الجانب الأيمن من واجهة البناية المجاورة.. وهي تشرئب بساق ضخمة.. فيما أعرفها الأكثر علواً تتهادى في ثباتها غير بعيد من ابواب الغرف الجانبية المفضية إلى بلكونات الطابق الرابع المحاطة بشبكة حديدية صدئة على أن الأمر يختلف حقاً حين أرنو إليها من هناك.. فأي سحر.. أية فتنة.. بل، أي جمال غامر أجدني سابحاً داخله وقتها.
ربما لهذا كنت أحرص في أيام الخميس على العودة قبل حلول ساعة الأصيل من جولاتي الغامضة في وسط المدينة. وكان ذلك وقتاً يسمح دائماً بدخول الحمام على عجل.. إعداد كوب من الشاي.. ثم الجلوس بحواسي كلها أمام غرفة السطح المؤجرة انتظاراً لظهور الشجرة.. المتعة.
بعد ثوان قليلة أشبه بدهر من اليأس والرجاء. أبدأ في التململ.. متنفساً بصعوبة وبطء.. مرتعشاً كمراهق على أعتاب القبلة الأولى.. بينما تنصب عيناي على نافذة موصدة في ظهر البناية المجاورة تقبع وراءها امرأة.. نافذة لا تفتح إلا نحو الساعة من كل أسبوع.. وكان ذلك في شهوره الأولى يثير حيرتي إلى حد بعيد.. قبل ان اتحول عنه تماماً إلى معشوقتي.. الشجرة.. كذلك لم يكن بوسعي.. ساعة ان تعرض جارتي.. في أيام الخميس.. عن فتح نافذة غرفتها.. ما بين السابعة والثامنة مساء «إذا كان الوقت صيفاً».. او الرابعة والخامسة «إذا كان الوقت في الشتاء» رؤية الشجرة في فروعها العالية العالية.
وأخياً أرخى أذني لصرير رتاج النافذة.. وهو يتناهى كمطلع سمفونية عبر الفراغ القصير القائم بين البنايتين.. ولا تمضى إلا ثانية واحدة.. حتى تلوح ذرى راحتيها.. ثم ذراعاها.. وهما يدفعان ضلفتي الشيش الأزرق الباهت نحو جانبي الحائط في جلبة.. لا أروع..
على هذا النحو.. كان وجه جارتي يطل على العالم.. ناظرا خطفا إلى أسفل.. أو إلى أعلى.. أو متلفتا يمنة ويسرة .. قبل ان يختفي داخل الشقة لأمر ما..
إذ ذاك فقط.. أستأنف رحلة النظر.. عبر النافذة المشروعة للتو.. إلى باب غرفتها الجانبي المفتوح على البلكونة و... «مشهد الفروع العالية»..
هكذا.. حين أشاهدها من أمام غرفة السطح المؤجرة.. وهي تخربش في دلال منغم وجه السماء.. ثم تنثني سعيدة بعودة الطيور الصغيرة المتعبة.. يجتاحني حب جارف تجاه الله والكون والجارة.
وأظل في تحديقي هذا.. غافرا لاعدائي ما قد تقدم أو تأخر.. إلى أن تطل ثانية.. وتغلق النافذة .. لينفتح في قلبي مثل جرح غائر.. باب السؤال: يا ترى.. هل سأشاهد الفروع.. بيت الطيور الصغيرة المتعبة.. مرة أخرى .. لولا وجه الجارة.. غلق النافذة .. وإختفاء باب غرفتها الجانبي لمدة ستة أيام متصلة .. لما صار كل هذا الرواء الجميل».
كنت أدخل السكينة إلى نفسي.. وأخاف.. إذا تغيبت في مرة قادمة لأي سبب.. كأن يأخذني النوم خلسة أو يرسل الله مطره الغزير ان يكمل الزمن دورتيه. ولا أراها.. وهي تميل سعيدة بعودة الطيور الصغيرة المتعبة.. قبل مرور ثلاثة عشر يوما بالتمام.
أذكر .. في هذه اللحظة ان النافذة ومنذ أسابيع خلت ظلت موصدة في مساءات الخميس رغم أني لم أنم ورغم ان الله لم يرسل مطره الغزير.. هذا الشتاء
نقلاً عن الرأي العام - بقلم عبد الحميد البرنس]